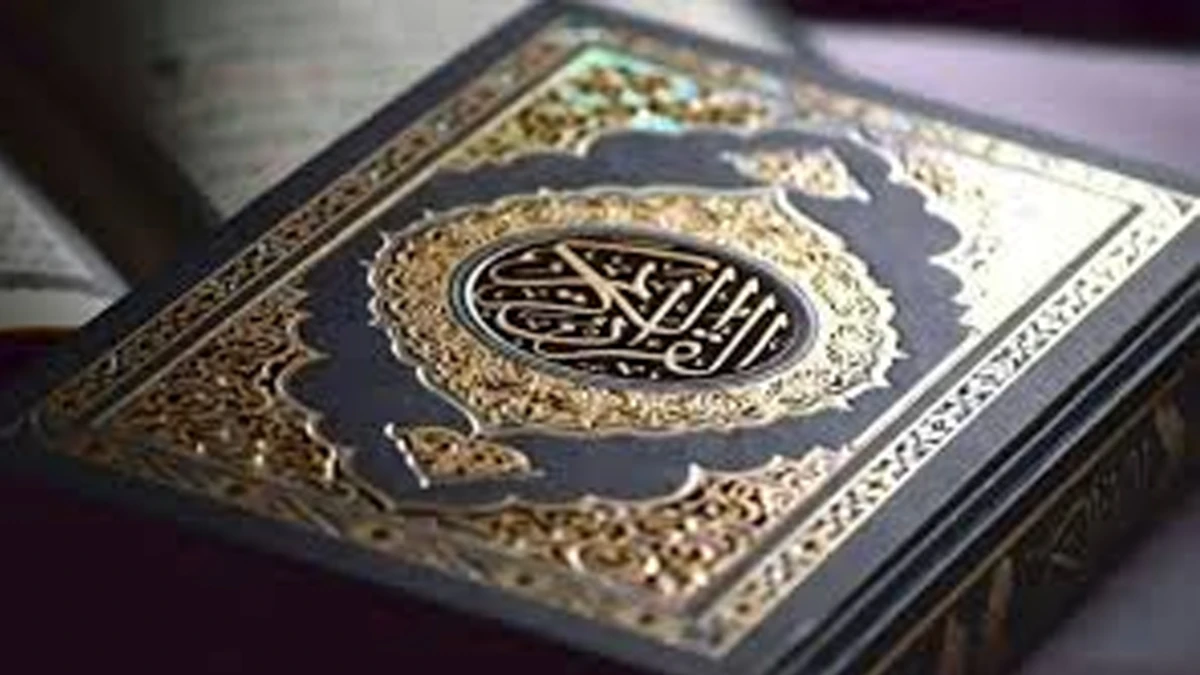

الملتزِم !
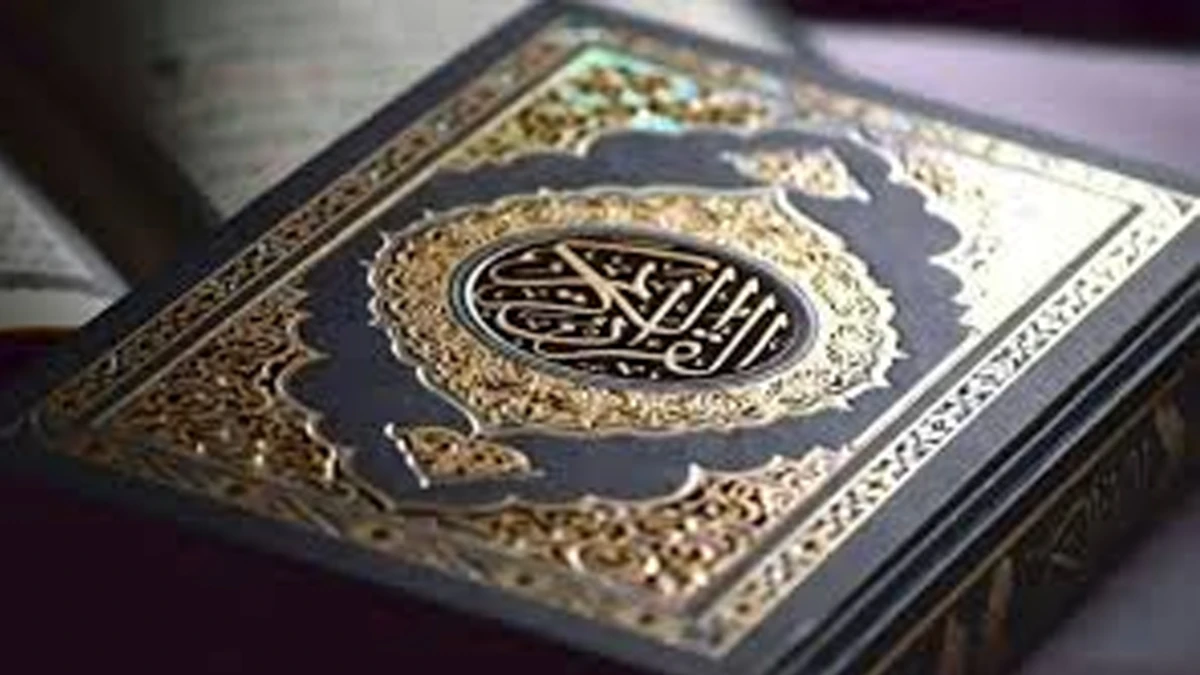
واحدة من أعقد القضايا التي لاكتها الألسنة والعقول في مرحلة سابقة وما زالت هو تحديد المقصود بالشخص الملتزم ؟
أولاً: من حيث التسمية الأصح .
وثانياً: وهو الأهم -تحت أي تسمية افترضناها-: ماهو الفرق بين المسلم الملتزم والمسلم غير الملتزم ؟ وهل يترتب على هذا التوصيف موقف شرعي واجب على الملتزم تجاه غيره؟
وسأبدأ بالمعنى لأنّه المهم ومن ثم نستطيع التوصيف والتسمية .
الحقيقة أنّه يلتبس كثيرا هذا المعنى ، لأنّنا متفقون جميعا على أمرين :
الأوّل: أنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب كبيرها وصغيرها، مهما بلغ العبد من العلم والجهاد والدعوة والتقوى . هذا في جانب المستوى الأعلى في التديّن .
الثاني: أنّه لا يكفر مسلم بالذنوب كبيرها ولا صغيرها، مادام موحداً لم ينقض إسلامه بشرك أو كفر ، وهذا في جانب الحدّ الأدنى من التدين.
وإذا تأملنا وجدنا كل المسلمين، برّهم وفاجرهم، مؤمنهم وفاسقهم، هم بين هذين الحدين، بين مقلّ ومستكثر، منهم من هو قريب إلى الحد الأعلى ، ومنهم من قصرت به همته فنزل إلى الحد الأدنى .
فأيّ معنىً تنزّله على الملتزم المفترض تجده موجوداً في غيره من عموم المسلمين، العبرة فقط بحجم التمسك بالدين، وهذا لم يأت به توصيف ولا اسم خاصٌ في الكتاب والسنة.
الأسماء في الشرع هي "مؤمن، مسلم، كافر، منافق، مشرك".
وهذه الأسماء جاءت معيارية في الأساس لا لتقسيم الناس، بمعنى أن يجتهد العبد أن يلحق بالاسم المرضيّ من الله وأن يبتعد عن كل ما يلصق به الاسم المسخوط.
فليس المهمّ بالدرجة الأولى أن نقول: فلان مؤمن أو منافق، وإن وردت به النصوص، لكن ليس هو الأصل في ذكر وتقسيم مراتب الناس.
وأقرب ما يكون لمعنى الملتزم هو اسم (المؤمن) ، لكن عندما ندقق فيه نجد أنّ العبد لا يخرجه عن اسم الإيمان إلاّ الوقوع في الكبائر مُصِراً عليها، أما من يقع ويتوب فلا .
كما أنّ الوقوع بذاته ليس مسوّغاً لإخراجه عن اسم الإيمان مالم تنتف الموانع وتتحقّق الشروط.
وهذا أمر بالغ التعقيد، ولهذا لم يُكَلّفْه المسلم إلاّ في أضيق الحدود، ولغرض ومقصد شرعيّ، ليس هذا محلّ الاستطراد فيه .
وكل هذا الذي قلته غير واضح في مقاصد الدعوة، أعني قضية الأسماء، ولهذا جُعِلَت عند أهل السنة من قضايا الأحكام، وسُمّي هذا الباب "باب الأسماء والأحكام".
لأنّ كل موحّد هو في الحقيقة مؤمن بالمعنى العام، وفِعْلُ الكبيرة بإصرارٍ يسلبه الاسم المطلق، لكنه لا يسلبه المعنى العام، فلا يقال هو مؤمن بإطلاق، لكنه داخل في جملة المؤمنين.
وإذا تأمل كل من يصنّف نفسه ملتزماً بالمعنى المعاصر يجد نفسه ليس بعيدا عن أخيه ذلك الذي يرتكب بعض المعاصي، لأنّه هو الآخر ليس معصوماً، ويقع فيما لعله أشد وأعظم من ذاك الّذي يُصنّف غير ملتزم
فكثيراً ما رأينا في أنفسنا وغيرنا من الكمالات لأنّنا – مثلاً- ملتحون ومقصّروا الثياب على السّنّة، بينما ربما نقع في الغيبة أو النميمة أو الفِرية أو استحلال المحرمات من الأموال والفُروج بتأويل نظنّه من العلم والفقه.
ونرى حولنا أشخاصاً لا يقعون فيما نقع فيه ربّما، لكنهم مثلاً حليقي اللحية مسبلي الثياب .
هذا أقوله للتوضيح وليس بالضرورة هو الصورة السائدة، فمن منّا الملتزم حقا ؟
إذا كان الظاهر هو الحَكَم فنحن الملتزمون وأولئك غير ملتزمين ، وإذا كان الأمر بحجم وقدر التمسك بأحكام الدين فهم الملتزمون ونحنلسنا كذلك .
أو يقال: إنّ كل مسلم ملتزم، والفرق بين الناس بحجم الالتزام، وبهذا تسقط التسمية وتصبح لغواً.
لكن هنا تبرز مسألة الظاهر والعنوان، فكيف يكون ملتزماً من شِعاره وظاهره الإعراض عن أحكام الدين وإن كان بتأويل أو اتباعاً لفتوى فقيه.
هذه الإشكاليات لم تكن بالهيّنة في نفوس كثير من المنتمين لبيئة التديّن ، وكثيراً ما كان يتمّ التوضيح للناس أنّ الملتحي ومن يسير معه ليس بالضرورة ملاكاً، وأنّ غيره لعله أكثر قرباً من الله .
لكن هذه الدّعوى لم تكن كافية لشرح الحالة ، وتفسير هذا التناقض بين ظاهر الأوّل الصالح بين وباطنه الملوّث، وكذلك بين باطن الثاني الصالح وظاهره الملوث.
هذه "اللخبطة" التصوريّة ناتجة عن سوء فهم للمقاصد الشرعية والحكمة من الابتلاء الرباني، وما يريده الله من العبد.
ومع أن النصوص بيّنت كثيراً من هذه الجوانب لكنّ الحالة النفسية الشعورية الفطرية دخلت على الخط -كما يقال- وأفسدت بطبيعتها المثالية أجواء الفهم الصحيح.
كيف ذلك ؟
أقول : الفطرة والنزعة المثالية فيها تفترض الكمال وتحبّه وتنزِع إليه ، وتكره التناقض أو النقص في الصورة أو أيّ تشويه لها، ولو كان يسيراً.
وهو التصوّر الفاسد الذي أوقع النصارى في الرهبانية، وكذلك الوثنيين في مواقفهم من الرسل ، إذ يفترضون في الداعي إلى الله بل وفي أيّ شخص ظاهره الالتزام بالأحكام الشرعية الكمالَ، وافترضوا كذلك في الأنبياء التنزّه عن كثير من الصفات البشرية ، كما حكى الله عنهم :{ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا} [الفرقان:7].
وهذه النزعة ذات شقّ شعوري ساذج موجود في عوامّ المسلمين بالفطرة دون تلقين، فبمجرّد رؤيتهم لعالمٍ أو داعية أو حتى مجرّد شخص ملتحٍ على معصية بل وحتى في بعض المباحات إذا هم يُنكرون ذلك منه مع تسويغهم للفعل نفسه من آخرين .
وموجودكذلك في النخب المثقفة المعادية للدّين والتي تشرّبت هذه النزعة من تاريخ أوروربا ومواقف رجال الدين الكَنسي من الناس وادّعاءهم للكمال بينما واقعهم تسلطٌ وفجور وظلم ، وبدلاً من تصحيح فُهومهم وفق التصوّر الشرعي الإسلامي أخذوا من ثقافة الغرب التسليم بقضية كمال رجل الدّين أو أي داعٍ إليه وافتراض ذلك فيه ضرورة وإلاّ كان كاذباً منافقاً.
والحقيقة التي بيّنتها السنة والشريعة وكانت مُسَلّمة منذ فجر النبوة : أنّ العبد مهما بلغ في الكمال فليس معصوماً.
وإعلان العبد التزامَه وتمسُّكَه بالشريعة إمّا فعلاً وذلك بمظاهر اللحية والثوب القصير أو الحجاب بالنسبة للمرأة ..
أو قولاً، وذلك بالدعوة والنصح بالتمسك بالأحكام الشرعية ..
كلّ ذلك ليس فيه دعوى عصمة من الذنوب، ولا إعلان سلامةٍ منها وتزكية للنفس بذلك .
وأنّ هذا العبد المعرّض للذنوب الكبير منها والصغير لا يسقط عنه واجب الدعوة إلى الله والأمر والنهي والنصح وتربية الأسرة والزوجة ومن حوله على الدين .
قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز:ِ"لَوْ أَنَّ الْمَرْءَ، لَا يَعِظُ أَخَاهُ حَتَّى يُحْكِمَ أَمْرَ نَفْسِهِ، وَيُكْمِلَ الَّذِي خُلِقَ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، إِذَنْ لَتَوَاكَلَ النَّاسُ الْخَيْرَ، وَإِذَنْ يُرْفَعُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقُلِ الْوَاعِظُونَ وَالسَّاعُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّصِيحَةِ فِي الْأَرْض".
لكن أليس هذا حالة نفاق؟
الحقيقة أنّ هذا نظريٌّ لا ثمرة له، لأنّ العبد مأمور بأمرين : الاستتار ، والتوبة ، وليس مأموراً بالكمال.
فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "اجتنِبوا هذه القاذوراتِ التي نهى اللهُ تعالى عنها ، فمن ألَمَّ بشيءٍ منها فلْيستَتِرْ بسِترِ اللهِ ، و لْيَتُبْ إلى الله ".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنّ رجلاً أذنب ذنباً فقال : أي ربّ أذنبت ذنباً فاغفر لي،فقال : عبدي أذنب ذنباً فعلم أنّ له ربّاً يغفر الذّنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثمّ أذنب ذنباً آخر، فقال : ربّ إنّي عملت ذنباً فاغفر لي، فقال : علم عبدي أنّ له ربّاً يغفر الذّنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثمّ عمل ذنباً آخر فقال : ربّ إنّي عملت ذنباً آخر فاغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى : علم عبدي أنّ له ربّاً يغفر الذّنب ويأخذ به، أشهدكم أنّي قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء".
قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : "شرَطَ بعض النّاس عدم معاودة الذّنب، وقال : متى عاد إليه تبيّنّا أنّ التّوبة كانت باطلة غير صحيحة .والأكثرون على أنّ ذلك ليس بشرط وإنّما صحّة التّوبة موقوفة على الإقلاع عن الذّنب والنّدم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته".
وفي المستدرك أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أحدنا يذنب، قال : يُكتب عليه، قال : ثمّ يستغفر منه، قال : يغفر له ويتاب عليه، قال : فيعود فيذنب، قال : يُكتب عليه، قال : ثمّ يستغفر منه ويتوب، قال : يُغفر له ويتاب عليه،ولا يملّ الله حتّى تملّوا".
وعن عليّ قال : «خياركم كلّ مفتّن توّاب» قيل : فإن عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب، قيل : فإن عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب، قيل : فإن عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب، قيل : حتّى متى ؟ قال : "حتّى يكون الشّيطان هو المحسور".
وعن سعيد الجريري قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، حتى متى ؟ قال :"ما أعلم هذا إلا أخلاق المؤمنين".
وقيل للحسن : ألا يستحي أحدنا من ربّه يستغفر من ذنوبه ثمّ يعود ثمّ يستغفر ثمّ يعود، فقال : "وَدّ الشّيطان لو ظفر منكم بهذه، فلا تملّوا من الاستغفار".
وأما أنه ليس مأمورا بالكمال فقال صلى الله عليه وسلم : "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا؛ لذهب الله بكم، ولجاء بقوم غيركم يذنبون، فيستغفرون الله؛ فيغفر لهم".
وقال: "كل بني آدم خطاء، وخير الخطّائين التوابون".
ثم لو قيل: إنه حالة نفاق، فلا أثر لهذا في التكليف الشرعي، فإنّ وجود شعبة من النفاق في المسلم أمر غير مستبعد ، لأنّ المؤمن إذا قام به أصل الإيمان فلا يمنع ذلك أن تقوم به شعبة كُفْر : وهي المعصية .
أو شعبة نفاق ، مثل الكذب والغدر أو الخيانة.
وهذا لا يتعارض مع كونه مؤمناً، فإن كان يتوب منها دائماً فهو مؤمن بإطلاق، وإن كان مُصِراً عليها مع الاستتار فهومن أهل العافية، قال صلى الله عليه وسلم : "كل أمتي معافى إلا المجاهرين".
وإن كان مُصِرا عليها مع المجاهرة بتأويل فهو مخطئ معذور .
وإن كان من غير تأويل فهو مؤمن ناقص الإيمان .
وفي كل هذه الأحوال يظلّ مؤمناً مأموراً بما أُمِر به كل مؤمن من البلاغ عن الله ونشر الدين وتربية من تحت يده على ذلك .
فالنصوص التي ذمّت حالاتٍ من التناقض بين الظاهر والباطن ليس مقصودها الكفّ عن الخير الموجود في العبد بسبب وجود الشر، بل المقصود الدفع نحو تصحيح الباطن ، ومع ذلك فهو خير من فساد الجهتين.
حسناً هل أجبنا على السؤال الأساس في المقال ؟
من هو الملتزم إذاً ، أو أنّه ليس هناك فرق بين المسلمين كلّهم إلاّ في قدر التمسك، فنقول إنّ المصلي العابد الحافظ للقرآن مثله مثل المطرب الفاسق والممثلة الفاجرة، لأنّهم كلهم مسلمين ملتزمين بأصل الدين ؟
الحقيقة أنّه لا وألف لا ، وكيف يستويان ؟ وقد قال تعالى : {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِين}[القلم:35].
وقال: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُون}[السجدة:18].
إذن ما هو حقيقة الحد الّذي يميّز الملتزم عن غيره إذا كان كلاهما موحّداً وكلاهما معرض للذنوب ؟
الحقيقة تبيّنت من كلامي السابق ..
فالملتزم، أو المتدين، أو المتمسّك، هو صنف خاص من أهل الإيمان العام ، يتميّز عن سائر أهل الإسلام بأنّه ذلك الشخص الذي يعيش للآخرة، ومقصد الآخرة والمآل إليها والدعوة إلى ما ينجي فيها واضح بيّن في ذهنه ونيّته، هذا هو الحد الذي يميز الملتزم الحقيقي من غيره .
ولا يهم بعد ذلك حاله من التمسك بالأحكام من التفريط .
ولهذا لا تعجب إذا قلت لك: إنّ شخصاً يصلي الفرائض الخمس ويصوم رمضان ويحج البيت ويتصدق بالأموال لكن لعلّه من حطب جهنم، ولا يُعدّ ملتزماً ..
وشخص يصلي مجاهداً نفسه بها، ويصوم ما قدّر له ويقع في ذنوب ومعاصٍ كبائر ومع ذلك هو في عليين -ربّما- ويُعدّ ملتزماً متمسكاً ..
الفرق بينهما: أنّ الأول، جعل دِينَه جزءاً من دنياه، فكلّ ما يعمله من العبادات والقربات لا يعدو كونه جزءاً من عمله للدنيا .. وهؤلاء غالبا لا تقوم بقلوبهم النوايا المشروعة للأعمال .. كما أنّهم كثيراً ما لا يأبهون بالحكم الشرعي إذا خالف هواهم، ولا يشعرون بقرصة قلب إذا واقع أكلاً للربا أو للمال الحرام، أو الفرج الحرام ..
فهو في سَفَر دائم إلى الدنيا، وما الآخرة إلاّ مجرّد محطة يمر بها في سفره هذا .
وأمّا الثاني – الملتزم- : فهو من كانت دنياه جزءا من آخرته .. فأعماله الدنيوية تجارةً وعلما وعملاً ونكاحا وطعاما وشرابا وغير ذلك كلّها لا تعدو في روتين حياته أن تكون جزءا من الصورة الكليّة لها، فمقصده الآخرة ..
وهو في سفر دائم إلى الآخرة، والدنيا مجرّد محطة في سفره هذا ..
إذا تصوّرت هذا الفرق وعلمتَه وأدركتَه جيداً عرفت أثره في حياة من حولك، وميّزت به الملتزم من غيره، المتديّن من غيره ..
ولهذا تجد كثيراً من الناس من التجار والمثقفين ورؤوس الناس بل ومن رموز العلمانيين فِكراً أو سُلوكاً أصحاب عباداتٍ وتقوى ظاهرة ..
وتجد في كثير من شباب ورجال الدعوة والملتزمين من أنواع النقص في أداء العبادات أو الوقوع في المعاصي والذنوب ..
وكثيرا ما نسمع من جهلة وحمقى الدعاة تعيير الشباب المؤمن بهذا ..
والحقيقة أنّ هذا لا يُنكَر ولا يهولك أبداً ..فليس ذلك – بالضرورة - دليل إيمان أولئك ولا فسق هؤلاء ..
والسبب، أنّ الأوّلين لا يجدون من قُطّاع الطريق من يقطع عليهم طريقهم، لأنّهم إلى الباطل سائرون وقد أراحوا الشياطين من مهمة إضلالهم، بل تجد هذه العبادات التي يلتزمها أحدهم كالمخدّر الذي يخدره عن إدراك مرض قلبه وموته، ولهذا قِيلَ لِبَعْضِ السَّلَفِ: إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ: نحن لَا نُوَسْوَسُ في صلاتنا.
فَقَالَ: «صَدَقُوا، وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْبَيْتِ الْخَرَابِ».
قلت : وهذا معنى ما روي عن ابن عباس وابن مسعود : "من لم تتنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلاّ بعداً" ، فإذا بلغ الأمر بالعبد أنّ صلاته لا تؤثّر فيه حتى بمجرد النهي وتحريك القلب فهي صلاة ميّتة مضرّة تشعره بالعافية بينما هو يزداد مرضا.
أمّا إذا قصد العبد ربّه وآخرته وبانت له أعلام الآخرة فقصَدها فلا تسل عن قطّاع الطريق عليه، لا أقول من الشياطين وأتباعهم من فجّار وفساق البشر ، بل أقرب الناس إليه يشارك في مهمة قطع الطريق عليه كما قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم}[التغابن:14].
ولهذا لا عجب أن تجد في هذا السائر إلى الله من آثار المكابدة في سفره إلى الآخرة ، من آثار الجراح والدماء التي تسيل منها بسبب كثرة السهام الموجهة إليه ..
والرسالة هي : لا تيأس من نفسك ولا من غيرك ما دمت على طريق الله .. مهما كنت فيه من النقص والضعف .
أقول هذا لا أسوّغ به المعصية .. وإنّما لأمرين :
الأوّل : حتى لا نغتر بأولئك الذين يتشدّقون بالتديّن وكثير منهم ينظّر على أهل التديّن والملتزمين ويذكر الأمثلة على فضائح أو نقص وقع فيه داعية أو عالم أو ملتزم من عامّة الناس ليدلّل على صحة تدينه هو وأمثاله ..
وهؤلاء وإن كان كثير منهم تلقّى تربية جيّدة على تعاليم معينة في أُسَر معروفة أو بيئات اعتادت على سلوكيات محددة.
لكن كما قلت لك: هي مجرّد جزء من دنياه .. ولهذا تجد الواحد منهم لا يرفع رأساً ولا يمتعض له وجه من رؤية منكر أو السماع به .. وهذه هي صفة قلب الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم: "تُعْرَضُ الفِتَنُ علَى القُلُوبِ كالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فأيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَها، نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ سَوْداءُ، وأَيُّ قَلْبٍ أنْكَرَها، نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ بَيْضاءُ، حتَّى تَصِيرَ علَى قَلْبَيْنِ، علَى أبْيَضَ مِثْلِ الصَّفا فلا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ ما دامَتِ السَّمَواتُ والأرْضُ، والآخَرُ أسْوَدُ مُرْبادًّا كالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، ولا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إلَّا ما أُشْرِبَ مِن هَواهُ".
فهذا قلب الكافر في الأصل لكن بعض المسلمين يصيبهم ما أصابه إذا تشبهوا به في هديه وطريقته.
وجملة "ما أُشرب من هواه" يدخل فيها ما ذكرته لك من أنواع القرب والعبادات التي اعتادها لهواه لا لحقّ الله.
والحقيقة المخيفة أن جماهير من المنتسبين للإسلام هم من هذه الطبقة عافانا الله منها، فهُم وإن نَجوا من الخلود في النار إذا ماتوا على التوحيد فهم أهل بليّة عظيمة وكثير منهم لا تثبت قدمه على الدّين إذا واجه الفتنة، وكثير منهم ممّن يقول في قبره : "هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون قولاً فقلته".
نعم ، كان دينُه مِن دين ما يسمع ممن حوله، لا يكترث بصوابه أو خطئه.. يقول ما قاله الناس .
والأمر الثاني: لأرفع به من شأني وشأن كل السائرين معي ممن هم مثلي احتوشتهم الذنوب والمعاصي وقَلّ مُعينُهم وناصرُهم، حتى لا نفقد الثقة بالله، ومن يعرف كم نكابد ونجاهد لأجل أن نبقى في الطريق .. نبطئ مرة .. نتوقف مرة، نتراجع مرات ، لكنا على الأقل على الطريق حتى تأتي ساعة الراحة من الدنيا ومن فيها ..
نسأل الله الثبات على ذلك.
هذه خلاصة الكلام في من هو الملتزم، أو المؤمن بإطلاق، أو المتديّن، وكلها أسماء لمسمى واحد، وهو: مَن أعلن التزامه بالشريعة .. إعلانا فعلياً بإظهار شعائرها الظاهرة ..
أو إعلانا قولياً بالدعوة إليها والنصح بها والحمية لها والدفاع عنها ..
وليس من شرطه السلامة من العيوب ولا من الذنوب خفيّها وظاهرها .
وفي هؤلاء قالت عائشة رضي الله عنها حين سُئلت عن المؤمن: "مَن سرَّتْه حسنته وسائته سيئته فهو مؤمن".
إذن فالمؤمن ذو سيئات وليس معصوماً، لكنّه مع هذا تسوءه السيئة ويتألّم منها .
الملتزم هو السائر إلى الله ولو لم يَصل : كما قال تعالى: {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [النساء:100]، غفوراً رحيماً به ولو لم يصل وقطَعه الأجل .
وأصرح من ذلك كله حديث قاتل المئة نفس، قال صلى الله عليه وسلم: " إنَّ عبدًا قتلَ تسعةً وتِسعينَ نفسًا ثمَّ عرضَت لَهُ التَّوبةُ، فسألَ عَن أعلمِ أَهْلِ الأرضِ، فدُلَّ على رجلٍ فأتاهُ فقالَ: إنِّي قتَلتُ تسعةً وتسعينَ نفسًا، فَهَل لي من توبةٍ؟ قالَ: بعدَ تِسعةٍ وتسعينَ نفسًا قالَ: فانتَضَى سيفَهُ فقتلَهُ، فأَكْملَ بِهِ المائةَ، ثمَّ عرضَت لَهُ التَّوبةُ، فسألَ عن أعلَمِ أَهْلِ الأرضِ، فدُلَّ على رجلٍ فأتاهُ فقالَ: إنِّي قتَلتُ مائةَ نفسٍ، فَهَل لي من تَوبةٍ؟ فقالَ: ويحَكَ، ومَن يحولُ بينَكَ وبينَ التَّوبةِ؟ اخرُج منَ القَريةِ الخبيثَةِ الَّتي أنتَ فيها إلى القريةِ الصَّالحةِ قَريةِ كذا وَكَذا، فاعبُدْ ربَّكَ فيها، فخرجَ يريدُ القريةَ الصَّالحةَ، فعرضَ لَهُ أجلُهُ في الطَّريقِ، فاختَصَمت فيهِ ملائِكَةُ الرَّحمةِ وملائِكَةُ العذابِ، قالَ إبليسُ: أَنا أولى بِهِ، إنَّهُ لم يعصِني ساعةً قطُّ، قالَ: فقالَت ملائِكَةُ الرَّحمةِ: إنَّهُ خَرجَ تائبًا» ، وفي رواية : «فاخْتَصَمَتْ فيه مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ ومَلائِكَةُ العَذابِ، فأوْحَى اللَّهُ إلى هذِه أنْ تَقَرَّبِي، وأَوْحَى اللَّهُ إلى هذِه أنْ تَباعَدِي، وقالَ: قِيسُوا ما بيْنَهُما، فَوُجِدَ إلى هذِه أقْرَبَ بشِبْرٍ، فَغُفِرَ له".
فهذا الرجل خرج من قريته وقد قتل تسعة وتسعين، وفي طريقه إلى الله قتل نفساً أخرى، ومع هذا غفر الله له لأنّه كان في طريقه إليه ..
قال تعالى :{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين} [العنكبوت:69] : السبل المهدية هي سبيل الله في الدنيا، وسبيل الجنة في الآخرة، وسبيل الله لا يسلم سالكها من الخطأ لكثرة عدوّه ومعارضيه فيه.
ولهذا غفر الله لسالك الطريق وكافأه على البقاء عليه وإن خرج مكلوماً مجروحاً من إبليس وأعوانه ، ولم يشترط عليه السلامة ، وإنّما طالبه بالصلة معه والمتابعة على الطهارة ..
فليس من شرط الولاية السّلامة من الذّنوب، وإنّما الشرط هو عدم الإصرار عليها والتّوبة منها، كما قال تعالى: {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُون * أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِين } [آل عمران:133-135]، ولا أصرح من هذه الآية على أنّ الرّجل قد يكون من المتّقين بل والمحسنين ومع ذلك فقد يقع منه الذّنب بل الفاحشة ولا يمنع ذلك من بلوغه مرتبة المتّقين أهل الجنّة، بشرط أنّه إذا فعل الفاحشة تذكّر وأقلع وتاب، فهو إذاً لا يصرّ على المعصية مع أنّه قد يقع فيها المرّة بعد المرّة لكنّه يتوب منها أيضاً كلّ ما وقع فيها .
وقال تعالى : {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِير}[فاطر:32] فجعل الظالم لنفسه من أمة محمّد التي اصطفاها، وهذا الظالم لنفسه هو الملتزم المقصر الذي يقع في الذنوب لكنه مع هذا معترف بتقصيره مستغفر، الآخرة همُّه والعمل لهذا الدّين مقصد له، يفرح بالخير ويحبّ أهله، ويكره الفسوق ويبغض أهله ، ولا يمنعه تقصيره وذنوبه من ذلك .
حتى قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء : "من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ}.
فقد بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب، دليل على أن الله اصطفاها في قوله: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} وبين أنهم ثلاثة أقسام:
الأول: الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله، ولكنه يعصيه أيضاً فهو الذي قال الله فيه {خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ}.
والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله، ولا يعصيه، ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات.
والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة، وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه، والمقتصد والسابق.
ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم، ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} إلى قوله: {وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ} والواو في {يدخلونها} شاملة للظالم، والمقتصد والسابق على التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: "حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين"، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة، وأولهم الظالم لنفسه يدل على أنّ هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من المسلمين أخد خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين".
قلت : صدق رحمه الله، ولكنّ الظالم لنفسه الذي لا يرى نفسه إلاّ صالحاً مصلحاً لا يشمله هذا الوعد بل هو من الصنف الأوّل الذي ذكرته لك، وهو ممن قال الله فيهم في صدر سورة البقرة : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُون* أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُون * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُون }[البقرة:11].
وهذا يدلك على خطورة الأمر في شأن هذه المسألة ، أعني من هو المسلم الملتزم وغير الملتزم ، والله أعلم وأحكم.
Powered by Froala Editor








